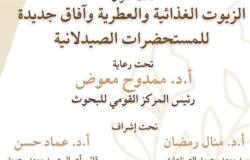لم تكن رحلة المرأة المصرية نحو نيل حقوقها السياسية، وعلى رأسها حق التصويت والترشح، مجرد مطلب قانونى عابر، بل كانت مسيرة طويلة من النضال والتحدى امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، شهدت خلالها النساء المصريات تحولات اجتماعية، وتراكمات نضالية، وصدامات ثقافية مع بنية مجتمعية وأحزاب محافظة طالما اعتبرت السياسة حكرًا على الرجال.
من مظاهرات ثورة 1919 بقيادة هدى شعراوى وصفية زغلول، إلى اقتحام درية شفيق البرلمان عام 1951 برفقة 1500 امرأة من عضوات "اتحاد بنت النيل"، خطّت المرأة المصرية طريقها بنفسها، وسط مقاومة شرسة من القوى التقليدية والدينية. ومع كل خطوة للأمام، كانت تزرع وعيًا جديدًا بحقوقها كمواطنة كاملة، لا تابعة أو مُلحقة برجل.
وجاء عام 1956 ليشكّل نقطة تحوّل تاريخية، حين نصّ دستور الجمهورية الأولى، بقيادة جمال عبد الناصر، لأول مرة على منح المرأة حق التصويت والترشح، وتُوّج ذلك بإصدار القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية. لم يكن ذلك مجرد "قرار من فوق"، بل تتويجًا لمعارك خاضتها النساء فى الشارع، وفى الصحافة، وفى قاعات المحاضرات والمطالبة والتظاهر.
ونتناول، هنا، المحطات الكبرى فى مسيرة حصول المرأة المصرية على حق التصويت، بدءًا من دورها فى ثورة 1919، مرورًا بمرحلة التنظيم المدنى والنسوى فى الثلاثينيات، وانتهاءً بالاقتحام الرمزى للبرلمان فى 1951، ثم صدور الدستور والقانون فى 1956. كما نرصد السياقين الإقليمى والدولي، وردود الفعل المجتمعية والإسلامية على هذا التغيير، ونستعرض الاقتباسات الأصلية من عبد الناصر ودرية شفيق التى شكّلت الذاكرة السياسية لهذا الإنجاز.

من الشارع إلى المشهد الوطني
جاءت ثورة ١٩١٩ بمثابة الزلزال الذى أعاد تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية فى مصر، وكان من أبرز تجلياتها خروج المرأة المصرية لأول مرة إلى الشارع العام فى تظاهرات سياسية، رافعة شعارًا وطنيًا جامعًا: "الاستقلال التام أو الموت الزؤام". لم تكن المرأة طرفًا هامشيًا فى هذا الحراك، بل انخرطت فيه كعنصر فاعل، مُعلنة بداية مرحلة جديدة من الوعى السياسى النسوي.
برزت شخصيات نسائية قوية فى مقدمة المشهد، على رأسهن هدى شعراوى وصفية زغلول وسيزا نبراوي، اللواتى لعبن دورًا مركزيًا فى تنظيم التظاهرات، وتوجيه النداءات الوطنية، وتوفير الغطاء الرمزى لخروج النساء. لم يكن الحراك عشوائيًا، بل منظمًا ومدروسًا، واستُخدمت فيه أدوات غير مألوفة آنذاك مثل كتابة البيانات السياسية والتنسيق مع قيادات الحركة الوطنية آنذاك.
فى ١٦ مارس ١٩١٩، خرجت آلاف النساء المصريات فى تظاهرة غير مسبوقة، جابت شوارع القاهرة ورفعت اللافتات المطالبة بالاستقلال، ونددت بممارسات الاحتلال البريطاني، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. سُجل هذا اليوم تاريخيًا كأول حراك نسوى جماهيرى منظّم فى مصر، ولا يزال يُحتفل به حتى اليوم كيوم للمرأة المصرية.
كان نزول المرأة إلى المجال العام بمثابة تحدٍ واضح للقيم التقليدية التى فرضت على النساء العزل داخل الفضاء الخاص. المشهد الذى رأى فيه الرجال نساء محجبات وسافرات يسرن جنبًا إلى جنب فى الشوارع للمطالبة بالحرية والاستقلال، لم يكن مجرد احتجاج سياسي، بل ثورة اجتماعية كاملة على مفاهيم التهميش والإقصاء.
رغم أن شعارات التظاهرات كانت تركز على الاستقلال السياسي، فإن وعى النساء فى تلك اللحظة التاريخية لم يكن غافلًا عن الترابط العميق بين تحرر الوطن وتحرر المرأة. أدركت القيادات النسوية أن الاستقلال الحقيقى لا يكتمل دون تحرر الإنسان كاملًا، رجالًا ونساء، من الاستعمار الخارجى والاستبداد الداخلي، بما فى ذلك الاستبداد الأبوي.
مثّل انخراط المرأة فى ثورة ١٩١٩ لحظة ولادة سياسية جديدة للنساء فى مصر، إذ أصبح لهن وجود حقيقى فى المشهد الوطني، ومطالب مشروعة لا يمكن تجاهلها. ومع انتهاء الثورة، بدأت القيادات النسوية فى تأسيس الجمعيات وتنظيم المؤتمرات النسائية، تمهيدًا لمرحلة جديدة من النضال الحقوقى الذى سيستمر لعقود، وصولًا إلى الحق فى التصويت عام ١٩٥٦.
وعي نسوى متصاعد
فى أعقاب ثورة ١٩١٩، بدأت المرأة المصرية تتجه بخطى ثابتة نحو التعليم، حيث أُتيحت لها لأول مرة فرص الانتساب إلى المدارس النظامية ثم إلى الجامعة المصرية. ورغم التحديات الاجتماعية، فإن تعليم المرأة أصبح قضية رأى عام، تبنتها النخبة الإصلاحية والقيادات النسائية على حد سواء. وكان تعليم البنات فى هذه المرحلة خطوة استراتيجية لتأهيل المرأة لدور أكبر فى المجتمع العام وليس فقط داخل الأسرة.
لم تقتصر الحركة النسوية فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين على مبادرات فردية، بل تطورت إلى كيانات مؤسسية، أبرزها "الاتحاد النسائى المصري" الذى أسسته هدى شعراوى عام ١٩٢٣، وكان يهدف إلى تحسين وضع المرأة قانونيًا واجتماعيًا وتعليميًا. كما ظهرت جمعيات أخرى مثل "جمعية الهلال الأحمر النسائي"، التى عملت فى مجالات الرعاية الصحية والإغاثة، ما أعطى المرأة دورًا عمليًا فى المجال العام.
انتقلت الحركة النسوية تدريجيًا من التركيز على قضايا الاستقلال الوطنى إلى طرح مطالب تتعلق بحقوق المرأة فى المجتمع والدولة. بدأ الوعى النسوى يبلور مفاهيم مثل "المواطنة الكاملة" و"المساواة أمام القانون"، وارتبطت هذه الأفكار بمطالب التعليم والعمل والمشاركة السياسية، التى طُرحت بشكل متزايد فى المنتديات العامة والصحافة النسائية.
كان المجتمع المدنى الوليد حينها، وخاصة الجمعيات الخيرية والتعليمية، هو المساحة التى تحركت فيها النساء بحرية نسبية، وحققن من خلاله تأثيرًا تدريجيًا فى المجتمع. هذه الجمعيات لم تكن مجرد مؤسسات رعاية، بل منابر للتثقيف والتعبئة، ومن خلالها بدأت النساء فى تطوير خطاب نسوى يطالب بالحقوق من داخل بنية الدولة وليس فقط عبر المواجهة السياسية.
بحلول منتصف الثلاثينيات، أصبحت المطالبة بـ"حق التصويت والترشح" حاضرة بوضوح فى خطاب الجمعيات النسائية، وبدأت الحملات المنظمة لمخاطبة الحكومة والبرلمان. إلا أن السلطة السياسية ظلت تماطل، متذرعة بأن المجتمع غير مستعد، وأن المرأة لم تصل بعد إلى درجة "النضج السياسي"، وهى الذريعة التى استخدمها أكثر من نظام لتأجيل منح الحقوق المدنية للنساء، سواء فى مصر أو باقى الدول العربية.
أمام استمرار التجاهل، بدأت القيادات النسوية فى رفع مستوى المواجهة. فبدلًا من الاكتفاء بالمناشدات والبيانات، صار النضال أكثر مباشرة وتنظيمًا. وأصبحت المشاركة فى المؤتمرات الدولية والاتصال بمنظمات نسوية عالمية وسيلة للضغط الخارجى أيضًا. كان هذا التحول مؤشرًا على تطور الحركة النسوية من طور التوسل إلى طور الفعل السياسى المنظم، وهى مرحلة نضج مهدت الطريق لحراك أكثر جذرية فى الخمسينيات.
درية شفيق واقتحام البرلمان
كانت درية شفيق واحدة من أبرز رموز الجيل الثانى من الحركة النسوية فى مصر، وقد تبنّت أسلوبًا أكثر جذرية فى المطالبة بحقوق المرأة مقارنة بالجيل الأول الذى مثّلته هدى شعراوي. حصلت درية على دكتوراه من السوربون، وكانت تؤمن بأن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة المناشدات إلى الفعل المباشر. جمعت بين الثقافة الغربية والرؤية الوطنية التحررية، ما جعلها شخصية قادرة على تحريك الرأى العام.
فى ظل تجاهل السلطة المستمر لمطالب النساء، نظّمت درية شفيق مظاهرة نوعية حملت طابعًا غير مسبوق: اقتحام مقر البرلمان نفسه. لم تكن خطوة عشوائية، بل سبقها تنسيق دقيق وتحشيد ضمن "اتحاد بنت النيل"، وهو التنظيم النسائى الذى أسسته درية ليكون ذراعًا نضاليًا نسويًا مستقلًا عن السلطة والأحزاب التقليدية.
فى صباح يوم ١٩ فبراير ١٩٥١، قادت درية شفيق ما يقارب ١٥٠٠ امرأة من عضوات الاتحاد إلى مبنى البرلمان المصري. دخلن المبنى بشكل منظم وسلمن مذكرة شاملة بمطالب النساء، وعلى رأسها حق التصويت والترشح فى الانتخابات، والمساواة فى التعليم والعمل. كان المشهد استثنائيًا: نساء من مختلف الطبقات والمشارب يجلسن فى بهو البرلمان، فى قلب السلطة التشريعية، يرفعن أصواتهن بلا خوف.
رفضت النساء مغادرة المبنى بعد تسليم المذكرة، وأعلنّ اعتصامًا استمر لعدة ساعات داخل البرلمان. كان ذلك تحديًا مباشرًا للسلطة، وتحول البرلمان، ولو مؤقتًا، إلى منصة صوت فيها الوجدان النسوى بقوة. هذا الاعتصام السلمى هزّ الرأى العام وأجبر الصحف والنخبة السياسية على التفاعل، خصوصًا مع الإصرار اللافت من النساء على البقاء حتى تُسجّل مطالبهن رسميًا.
وجد البرلمان نفسه فى موقف حرج، إذ لم يكن من السهل قمع النساء دون إثارة موجة من الغضب المجتمعي، خصوصًا أن المظاهرة كانت سلمية ومنظمة وتحمل مطالب دستورية. وافق المسؤولون فى النهاية على تسلّم المذكرة ووعدوا بمناقشة مطالب النساء، فى محاولة لاحتواء الحدث دون تقديم التزامات واضحة. لكن الحراك نفسه كان قد أحدث شرخًا فى جدار الصمت السياسى حول حقوق النساء.
شكّل هذا الاقتحام والاعتصام لحظة تاريخية فاصلة فى نضال المرأة المصرية، إذ انتقل الحراك النسوى من الهامش إلى قلب مؤسسات الدولة. لم يعد بإمكان أى سلطة أن تتجاهل المطالب النسوية باعتبارها "غير ناضجة" أو "سابقة لأوانها". لقد أكدت درية شفيق ورفيقاتها أن المرأة ليست تابعًا فى المشهد الوطني، بل فاعلة قادرة على قيادة التغيير، الأمر الذى مهد الطريق أمام نيلها حقوقها السياسية بعد خمس سنوات فقط.
دستور ١٩٥٦ وقانون مباشرة الحقوق السياسية
مثّلت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ نقطة تحوّل جذرية فى المشهد السياسى والاجتماعى المصري. وبرغم أن الضباط الأحرار الذين قادوا الثورة لم يأتوا بخطاب نسوى معلن فى بدايتهم، إلا أن التوجه العام للإصلاح الاجتماعى والعدالة فتح الباب أمام مراجعة عدد من الملفات المغلقة، وعلى رأسها ملف حقوق المرأة، الذى ظل معلقًا لعقود رغم نضال الأجيال النسوية المتعاقبة.
فى ظل زخم التغيير الذى أحدثته الثورة، بدأ النظام الجديد بقيادة جمال عبد الناصر يرى فى المرأة شريكًا فى مشروع بناء الدولة الحديثة، وليس مجرد كائن تابع. ومن هذا المنطلق، ظهرت إشارات إيجابية مبكرة نحو إشراك النساء فى الحياة العامة، خاصة مع احتياج النظام إلى قاعدة شعبية واسعة لدعم شرعيته السياسية والاجتماعية.
فى ١٦ يناير ١٩٥٦، صدر دستور جديد للبلاد، حمل لأول مرة فى التاريخ المصرى نصًا واضحًا وصريحًا يمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، مساويًا إياها بالرجل فى الحقوق السياسية. لم يكن هذا النص مجرد تعديل قانوني، بل اعترافاً تاريخياً بأن المرأة المصرية مواطنة كاملة الأهلية، تملك القرار والصوت، والمكان فى الحياة النيابية.
بعد الإعلان الدستوري، صدر القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦، المعروف باسم "قانون مباشرة الحقوق السياسية"، الذى نص على تنظيم العملية الانتخابية وخفض سن التصويت إلى ١٨ عامًا. ولأول مرة، أُدرجت النساء فى جداول الناخبين، وأصبح بإمكانهن ليس فقط الإدلاء بأصواتهن، بل أيضًا الترشح والمنافسة على المقاعد البرلمانية والبلدية.
على الرغم من أن القرار جاء فى عهد عبد الناصر، إلا أن أهميته لا يمكن فصلها عن عقود من النضال النسوي، بدأت من ثورة ١٩١٩، وبلغت ذروتها مع درية شفيق واقتحام البرلمان عام ١٩٥١. إن ما جرى فى ١٩٥٦ لم يكن منحة، بل استجابة متأخرة لحركة مجتمعية عميقة، أثبتت فيها المرأة قدرتها على الفعل والضغط والتأثير.
منذ ذلك الحين، دخلت المرأة المصرية مجال السياسة بشكل قانونى ورسمي. صحيح أن مشاركتها كانت محدودة فى البداية، لأسباب اجتماعية وثقافية، لكن الباب قد فُتح. أصبحت المرأة ناخبة ومرشحة ومؤثرة، وتحولت من موضوع للوصاية إلى فاعل سياسى واجتماعي، يخطو خطوات ثابتة نحو التمكين الكامل.
السياق الدولي: الموجة العالمية لحقوق المرأة
جاء الاعتراف بحق المرأة فى التصويت فى مصر عام ١٩٥٦ فى سياق تاريخى عالمى كانت فيه قضايا النساء تشهد تحوّلًا جذريًا. فقد أدى انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى تغيرات اجتماعية وسياسية واسعة، منها إدراك أهمية دور النساء فى الحياة العامة، بعدما شاركن بقوة فى ميادين العمل والإنتاج خلال سنوات الحرب. هذا الزخم أدى إلى منح المرأة فى دول عدة حقها السياسي، حيث حصلت الفرنسيات على حق التصويت عام ١٩٤٤، تلاها الإيطاليات عام ١٩٤٥، واليابانيات عام ١٩٤٧، والهنديات عام ١٩٥٠ بعد استقلال البلاد. بدأت تتشكل بذلك موجة دولية تعترف بالمرأة كمواطنة كاملة، لا مجرد تابعة للرجل أو أسيرة للفضاء الخاص.
لم تكن مصر بمنأى عن هذه التحولات، بل كانت فى موقع تفاعل نشط مع هذا الحراك العالمي، خصوصًا أن النخبة المصرية آنذاك كانت تتابع باهتمام تطورات الحركة النسوية الدولية، وشاركت شخصيات نسوية مثل هدى شعراوى ودرية شفيق فى مؤتمرات نسائية عالمية. كما كانت الصحف والمجلات النسائية تنقل أخبار نيل النساء حقوقهن فى أوروبا وآسيا، مما ولّد طموحًا متزايدًا داخل مصر لمواكبة هذا التقدّم. وعندما صدر دستور ١٩٥٦ متضمنًا حقوق المرأة السياسية، لم يكن ذلك استجابة داخلية فقط، بل تعبيرًا أيضًا عن رغبة الدولة المصرية فى أن تظهر بمظهر الدولة الحديثة التى تواكب روح العصر وتتبنّى قيم العدالة والمساواة أسوة بالمجتمع الدولي.
الريادة المصرية عربيًا
تُعد مصر من أوائل الدول العربية التى منحت المرأة حق التصويت والترشح، وذلك بموجب دستور ١٩٥٦، فى وقت كانت فيه معظم الدول العربية لا تزال تناقش مدى "أهلية" المرأة للمشاركة فى الحياة العامة. جاء هذا التقدم نتيجة تراكم نضال نسوى امتد لعقود، ولقناعة سياسية لدى النظام الجديد بضرورة إشراك المرأة فى بناء الدولة الحديثة. وللمقارنة، حصلت المرأة الجزائرية على هذا الحق بعد استقلال البلاد عام ١٩٦٢، ونالت المرأة التونسية حق التصويت عام ١٩٥٧، أى بعد عام من مصر، فيما تأخرت المغرب حتى عام ١٩٦٣.
تُظهر هذه الفروقات الزمنية أن التجربة المصرية كانت رائدة إقليميًا، ومثّلت نموذجًا ملهمًا للحركات النسوية فى البلدان العربية. وقد تابعت تلك الحركات التجربة المصرية باهتمام، خاصة من حيث التنظيم النسوى والنضال السياسى والتفاعل مع مؤسسات الدولة. الأهم أن مصر لم تكتفِ بالمبادرة القانونية، بل دفعت أيضًا نساءها إلى دخول المعترك السياسى من خلال الانتخابات والمناصب العامة. وفى المقابل، ظلّت دول أخرى، وعلى رأسها السعودية، تُمانع حتى العقود الأخيرة؛ إذ لم يُمنح هذا الحق للنساء السعوديات إلا فى عام ٢٠١٥، أى بعد مصر بستة عقود كاملة، مما يعكس حجم الفجوة بين الريادة المصرية وبطء الإصلاح فى بعض دول الإقليم.
تحفظات اجتماعية وشكوك ثقافية
رغم أن منح المرأة المصرية حق التصويت والترشح فى عام ١٩٥٦ مثّل إنجازًا تشريعيًا كبيرًا، إلا أن هذا التغيير لم يُقابل بإجماع داخل المجتمع. برز التيار الإسلامى – خاصة الإخوان المسلمين والسلفيين – كأكثر الجهات رفضًا لهذا التغيير. فقد اعتبر الإسلاميون منح المرأة حق الترشح والانتخاب "خروجًا على الشريعة"، و"تشبّهًا بالغرب الكافر"، وروّجوا لفكرة أن السياسة ليست من اختصاص النساء، بل مجال يقتصر على الرجال. وعبر منشوراتهم وخطبهم، حذّروا من أن مشاركة المرأة ستؤدى إلى "فساد المجتمع" و"تلاشى الحياء"، وشنّوا هجومًا مباشرًا على القيادات النسوية، وخصوصًا درية شفيق، التى وُصفت بأنها "عميلة لفكر غربى هدّام".
ورغم أن الدولة مضت فى تنفيذ القانون، فإن البيئة الاجتماعية بقيت مقاومة بدرجات متفاوتة، ما أبطأ من وتيرة تمكين النساء فعليًا فى الحياة السياسية، وأبقى تمثيلهن محدودًا لعقود طويلة بعد صدور القانون.