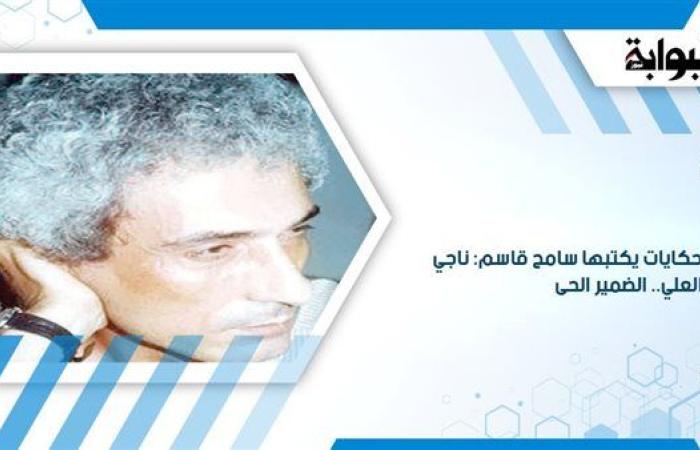حنظلة الطفل الذى أدار ظهره للعالم ليصير شاهدًا على صمت الضمير أمام إبادة البشر.. رسومات ناجى العلى ستظل جسرًا بين الحكاية الفلسطينية ووجع البشرية كلها.. دفع حياته ثمنًا لقول الحقيقة مجردة بلا أقنعة
حين نستحضر اسم ناجي العلي، تُفتح أبواب واسعة على أكثر من ذاكرة، وأكثر من جرح، وأكثر من معنى. ليس مجرد فنان عابر ترك لوحات متفرقة، وليس مجرد رسام كاريكاتير صاخب في مرحلة مضطربة، وإنما ظاهرة كاملة تشكّلت من تفاصيل حياة صعبة، وصارت مرآة جلية لوعي أمة بأكملها. كل خط رسمه كان يخرج من أعماق مأساة شخصية، ويتحوّل إلى احتجاج جمعي، كأن اليد التي تمسك بالقلم كانت يد آلاف اللاجئين والمتعبين والمقهورين في آن واحد.

وُلد ناجي العلي في قرية الشجرة في الجليل عام ١٩٣٧، في زمن كانت فيه فلسطين على وشك الدخول في واحدة من أعقد مآسيها. لم يكن طفلًا عاديًا يستيقظ على أصوات الطيور ويجري في بساتين الزيتون وحسب، وإنما كان شاهدًا صغيرًا على انكسار تاريخي سيحوّل حياته إلى رحلة طويلة من التيه. حين هُجّر مع عائلته بعد نكبة ١٩٤٨، كان الوعي لايزال غضًا، إلا أن ذاكرة الطفل لم ترحم براءته. احتفظ بصورة البيوت التي صودرت، والطرقات التي انقطعت، والسماء التي ضاقت، وكأن قلبه الصغير صار خزانًا لجراح أكبر من عمره.
تجربة اللجوء المبكر تركت أثرها العميق في تكوينه النفسي والفكري. لم يعرف الطمأنينة التي تمنحها الطفولة، ولم يتذوق الاستقرار الذي يسمح للإنسان أن ينمو دون خوف دائم من الفقد. المخيم الذي لجأ إليه مع أسرته كان أول مدرسة حقيقية له، مدرسة قائمة على الخوف والانتظار والحرمان. هناك، بين الخيام الضيقة والطرقات الموحلة، تشكّل وعيه الأول. كان يرى الفقر ماثلًا في الأجساد النحيلة، ويشاهد اليأس في عيون الكبار، لكنه كان يلمح في الوقت نفسه بذورًا من العناد والإصرار لدى الناس الذين رفضوا أن ينكسروا تمامًا.
هذه الطفولة الممزقة لم تكن عبئًا عليه فقط، وإنما كانت الشرارة التي أوقدت بدايات فنه. في تلك السنوات المبكرة تعلّم أن التعبير لا يكون بالترف، وإنما بالحاجة الملحة، وأن الرسم يمكن أن يكون لغة أوسع من الكلام. كانت الخربشات الأولى على جدران المخيم أو على دفاتر المدرسة محاولة فطرية لتثبيت صور يخشى أن تتلاشى في ذاكرة محاصرة بالخسارة.

الرسم فعل مقاومة
حين أمسك ناجي العلي القلم لأول مرة، لم يكن يبحث عن تسلية طفل يملأ فراغه، وإنما كان يفتش عن وسيلة يواجه بها عالمًا ضيقًا يطبق على صدره. الرسم بالنسبة إليه لم يكن هواية عابرة، وإنما ضرورة وجودية، كأنه اختار أن يحول الورق إلى ساحة معركة، والخطوط السوداء إلى رصاصات لا تُصيب الأجساد ولكنها تُصيب الضمائر. من هنا بدأ يتشكل وعيه بالفن: أنه ليس للزينة، وإنما للفضح والمساءلة والاحتجاج.
لقد رأى منذ بداياته أن الاحتلال لا يكتفي بمصادرة الأرض، وإنما يمد يده إلى الذاكرة والوعي، وأن الصمت يفتح الباب أمام موت آخر أشد قسوة من موت الجسد. لذلك قرر أن يجعل من الرسم فعل مقاومة يومي، يزرع به الشكوك في خطاب الزيف، ويوقظ به الناس من سباتهم. كان القلم في يده سلاحًا لا يقل عن البندقية، لأنه يفضح من يحاولون تزييف الحقائق، ويكشف عورات من يتسترون بالشعارات.
كل لوحة عنده كانت ساحة مواجهة، وكل خط فيها كان يحمل معنىً سياسيًا وأخلاقيًا في آن واحد. لم يكن يرسم من أجل الضحك الخفيف الذي يثير ابتسامة عابرة، وإنما كان يجرّح الضمير، ويزرع في العين دمعة ساخنة خلف ابتسامة مرة. كان يعرف أن الصورة تذهب مباشرة إلى القلب، وأنها قادرة على أن تقول في لحظة ما تعجز عنه الخطب الطويلة. لذلك أصبحت رسوماته أشبه ببيانات مختصرة، تفضح وتدين وتحرض، لكنها تفعل ذلك بذكاء الصورة وسحر الخطوط.
إن خصوصية تجربته أنه لم يتعامل مع الرسم كفن محايد، وإنما كالتزام كامل. كان يعتقد أن الفنان الذي لا يحمل هموم شعبه يعيش في فراغ، وأن اللوحة التي لا تنطق بالحقيقة تتحول إلى ورقة ميتة. لذلك ظل طوال مسيرته يتعامل مع الكاريكاتير كمسئولية أخلاقية، يضع أمام
عينيه أن جمهوره ليس القراء في الصحف فقط، وإنما الأمهات اللواتي ينتظرن أبناءهن على الحواجز، والأطفال الذين يبحثون عن معنى للحياة وسط الركام.
هكذا تحوّل الرسم عنده إلى معركة مستمرة ضد الاحتلال، وضد القمع، وضد الفساد الداخلي. كان يوزع السهام على الجميع بلا خوف، ويقف وحيدًا في مواجهة منظومات كاملة من التضليل. وربما لهذا السبب ظل فنه حيًا حتى اليوم، لأنه لم ينحصر في لحظة سياسية ضيقة، وإنما ارتبط بحقيقة أعمق: أن مقاومة الظلم لا تحتاج إلى سلاح واحد، وأن الخطوط السوداء حين تصدر من قلب صادق تصبح أداة لا تهزم.

ولادة حنظلة
في أواخر ستينيات القرن العشرين، خرج من يد ناجي العلي كائن صغير سيصبح لاحقًا أكثر حضورًا من كثير من القادة والسياسيين. كان طفلًا رقيق الجسد، شائك الشعر، حافي القدمين، واقفًا بظهره نحو العالم، اسمه حنظلة. لم يكن مجرد رسم عابر في زاوية صحيفة، وإنما مولود جديد للذاكرة الفلسطينية، كأن الفنان قد سلخ جزءًا من طفولته ورماه على الورق ليعيش حياة أخرى لا تنتهي.
حنظلة لم يأتِ بملامح مفصلة، فلا وجه له ولا عينان ولا فم، وكأنه تجسيد لإنسان محروم من حق التعريف بنفسه. ومع ذلك صار أقوى من آلاف الصور المكتملة، لأنه حمل سرًّا لا يُفك بسهولة: سر الرفض الصامت. حين أداره ناجي العلي بظهره نحو العالم، كان يعلن أن هذا الطفل لن يستدير إلا يوم تعود فلسطين إلى أهلها، ولن يكبر إلا حين يستعيد الناس كرامتهم. وهكذا تحوّل الطفل الغامض إلى شاهد أبدي على الانتظار الطويل.
لم يكن حنظلة شخصية فنية وحسب، وإنما كان ضميرًا دائمًا يرافق كل لوحة. أطلّ في رسومات ناجي العلي كشاهد لا يشارك في المهزلة، كطفل يعرف الحقيقة لكنه يترك للآخرين أن يواجهوها. وجوده في اللوحة أشبه بتوقيع أخلاقي، يحرس المعنى من أي التباس. فإذا ظهر، أدرك القارئ أن ثمة موقفًا جادًا، وأن ما يُقال ليس مجرد سخرية، وإنما صرخة لها جذور في الجرح.
حنظلة لم يُولد من فراغ، وإنما وُلد من سيرة كاملة عاشها ناجي العلي. هو صورة الطفولة التي انقطعت في لحظة النكبة، وهو رمز اللجوء الذي لا يعرف الاستقرار، وهو تعبير عن
جيل بأكمله حُكم عليه بالانتظار. لذلك صار هذا الطفل الشائك أكثر من رمز فني، صار أيقونة أخلاقية تتجاوز الزمان والمكان. أينما وُضع، سواء على جدار في المخيم أو على ورق صحيفة أو حتى على جدار مدينة بعيدة، كان يعلن أن هناك قضية لم تُحل، وأن هناك ظلمًا لم يُرفع.
ولادة حنظلة كانت إعلانًا عن أن الفن قادر على أن يمنح الرموز حياة تفوق حياة البشر. فالطفل الذي ظهر عام ١٩٦٩ لا يزال حيًا حتى اليوم، يراقب من بعيد، يذكّر الناس أن الطريق لم يكتمل. لقد صنع ناجي العلي بشخصية واحدة ذاكرة جماعية، ومنح أمة بأكملها طفلًا يحرسها من النسيان.
لم يكن طريق ناجي العلي مفروشًا بالتصفيق، ولم يكن قلمه يمرّ بين الورق مرورًا آمنًا. منذ اللحظة الأولى، اتخذ الفن عنده شكل المواجهة، والمواجهة تعني العداوات. لم يكن يوجّه سهامه نحو عدو واحد، وإنما نحو كل من يساهم في سحق الإنسان الفلسطيني والعربي، سواء كان احتلالًا واضحًا أو سلطة محلية أو نظامًا متخفيًا وراء الشعارات. وهنا بدأ قلب لوحاته يتحول إلى ساحة صراع، وبدأت النيران تتصاعد من خطوطه السوداء.
الاحتلال الإسرائيلي كان أول خصومه، ذلك الذي سلب الأرض وحوّل الفلسطيني إلى لاجئ. غير أن الأمر لم يتوقف عنده، فقد وسّع الفنان مجال الصراع ليشمل الأنظمة العربية التي شاركت بالصمت أو التواطؤ، وأولئك الذين رفعوا شعارات التحرير فيما كانوا يمدون أيديهم إلى مصالح ضيقة. كان يرى أن الخيانة لا تأتي فقط من الخارج، وإنما تتسرب من الداخل، وأن الصمت أخطر من الرصاص. لذلك كان يهاجم بلا تردد، غير آبه بما قد يترتب على ذلك من خسارات شخصية أو مهنية.
هذه الجرأة جعلت لوحاته تشبه مرايا قاسية، تعكس ما لا يريد كثيرون أن يروه. كان يرسم القادة العرب بملامح مشوهة، ويضعهم إلى جانب المحتل في المشهد نفسه، كأنه يقول إن الظلم واحد مهما اختلفت أزياؤه. وكان ينتقد بعض القيادات الفلسطينية حين يرى أنها انحرفت عن المسار، فحوّل الكاريكاتير إلى محكمة مفتوحة لا تعرف المجاملة. ومن هنا جاءت الحرائق: كل لوحة كانت تشعل جدلًا، وكل صحيفة تنشر رسوماته تتحول إلى ساحة معركة سياسية.
لم يكن ناجي العلي يهرب من هذه المواجهات، بل كان يتغذى عليها. كان يدرك أن الفنان الذي لا يثير الغضب يعيش في هامش الحياة، وأن قيمة القلم تتحدد بقدرته على إرباك المألوف. لذلك ظل يدخل إلى مناطق محرّمة، يقترب من جراح مسكوت عنها، ويكشف وجوهًا كان أصحابها يفضلون أن تظل مختبئة خلف ستائر القوة.
ومع تراكم هذه المواجهات، صار ناجي العلي شخصية ملتبسة بالنسبة إلى السلطات. فهو محبوب من الناس الذين يجدون في رسوماته صوتهم الضائع، ومكروه من أصحاب القرار الذين يرون فيه خطرًا يفضح أسرارهم. ومن هذا التناقض وُلدت العداوات التي رافقته حتى اللحظة الأخيرة من حياته. كان يعيش في دائرة نار لا تنطفئ، ومع ذلك ظل يخط على الورق ببرود يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
لقد كان يعرف أن الثمن سيكون باهظًا، وأن فنه لن يتركه يهنأ بحياة هادئة، إلا أنه ظل مصرًا على موقفه. فالرسام الذي انطلق من المخيم لم يكن يبحث عن أمان شخصي، وإنما عن أمان جماعي، عن عدالة لشعب كامل. ومن أجل ذلك قَبِل أن يكون هدفًا للرصاص والكراهية، وواصل السير في طريق محفوف بالحرائق حتى النهاية.

الغربة والمنفى
حياة ناجي العلي لم تعرف الاستقرار، ولم تمنحه المدن التي أقام فيها سوى شعور مؤقت بالمأوى. منذ خروجه الأول من فلسطين صار المنفى قدره الأبدي، يتنقل من مكان إلى آخر حاملًا معه حقيبة صغيرة وقلبًا مثقلًا بالحنين. كانت كل مدينة يقيم فيها تبدو كأنها محطة عابرة في قطار لا يتوقف عند أي رصيف طويلًا. من لبنان إلى الكويت إلى لندن، كان الفنان يعيش الغربة بوصفها وجهًا آخر من وجوه النكبة، امتدادًا للفقد الأول الذي لم يندمل.
المنفى بالنسبة إليه لم يكن مجرد انتقال جغرافي، وإنما جرح متحرك. فالمكان لا يمنح اللاجئ جذورًا، مهما امتد بقاؤه فيه، والبيت المؤقت يظل مؤقتًا حتى لو استمر لعقود. لذلك ظل ناجي العلي يشعر أنه ينام في غرف مستعارة، ويمشي في شوارع غريبة، ويكتب على جدران ليست له. وفي كل مرة كان يرسم، كان يحاول أن يعيد تشكيل فلسطين في صورة أو خط، كأنه يقيم وطنًا بديلًا على الورق ليقاوم هذا الاقتلاع المستمر.
الغربة صنعت منه عينًا أكثر حدة. فهو حين ينظر من بعيد يرى الوطن بوضوح أكبر، يرى تفاصيله التي ضاعت، ويستعيد ألوانه التي بهتت في الذاكرة. وكأن المسافة بينه وبين فلسطين لم تُبعده عنها، وإنما جعلته أكثر قدرة على إعادة تصويرها. كان يرسم المخيمات في الكويت، ويرسم الشجرة المقتلعة في لندن، ويكتب على الصحف الأجنبية صورة جدار في الجنوب اللبناني. أينما ذهب، كان يحمل معه فلسطين كظل لا يفارقه، يضعها في مقدمة اللوحة، ويجعلها الحاضر الدائم في كل مشهد.
ومع أن الغربة فتحت له أبوابًا للعمل، فإنها فتحت له أيضًا أبواب الوحدة. فالفنان الذي يعيش بعيدًا عن أرضه يعيش دائمًا شعورًا مزدوجًا: امتنانًا للمكان الذي يستقبله، ومرارةً لكونه مكانًا ليس له. وفي هذا التمزق عاش ناجي العلي حياته. كان يتلقى الحب من جمهوره العربي أينما ذهب، لكنه في أعماقه يعرف أن هذا الحب لا يعوّض غياب بيت واحد في قريته الأولى.
المنفى أيضًا كان امتحانًا أخلاقيًا. فهو يضع الإنسان أمام السؤال الأصعب: كيف تحافظ على هويتك في أرض ليست أرضك؟ وكيف تظل وفيًا لذاكرتك وأنت محاط بوجوه لا تشاركك الحكاية نفسها؟ نجح ناجي العلي في تحويل هذا الامتحان إلى رصيد فني.

الاغتيال بوصفه إتمامًا للحكاية
اغتيال ناجي العلي لم يكن حدثًا عابرًا في سجل الدم العربي، وإنما كان ذروة لحكاية طويلة عاشها بين الخطوط السوداء والبيضاء. كأن حياته كلها كانت تمهيدًا للحظة الرصاص التي اخترقت رأسه في أحد شوارع لندن، المدينة التي لم تكن تعرف أنه يحمل في حقيبته وطنًا كاملًا. لم يكن موتًا صامتًا، وإنما بيانًا أخيرًا كتبه بدمه، ليؤكد أن الكلمة الحرة تساوي حياة كاملة، وأن الرسمة الصغيرة يمكن أن تهدد إمبراطوريات.
منذ سنواته الأولى في المخيم كان ناجي يعرف أن قلمه لن يُسامَح. كان يتنبأ أن خطه الحاد سيكلفه ثمنًا غاليًا. كل لوحة يرسمها كانت خطوة باتجاه المصير، وكل شخصية ساخرة كان يرسمها كانت تزيد من عدد خصومه. ومع ذلك لم يتوقف. كان يسير نحو قدره بوعي كامل، كأن الاغتيال جزء من المشهد النهائي الذي سيمنح فنه المعنى الأخير.
حين أُعلنت أنباء اغتياله، لم يكن الخبر مجرد خبر عن موت فنان، وإنما إعلان عن محاولة لقتل الضمير الذي لم يتوقف عن الإزعاج. لم يكن الذين خططوا للرصاص يهدفون إلى إسكات رجل واحد، وإنما كانوا يطمحون إلى إسكات فكرة، إلى إلغاء مرآة تكشف عيوبهم كل صباح. لكن المفارقة أن الدم الذي سال لم يُنهِ صوته، وإنما جعله أعلى، ولم يمحُ أثره، وإنما ثبته في الذاكرة الجمعية.
اغتياله أعاد تذكير الناس بأن الفن الحقيقي ليس ترفًا، وإنما مواجهة مباشرة مع القوى التي لا تحتمل الحقيقة. كثيرون يرسمون ليزينوا الجدران، أما ناجي فقد رسم ليحطم الجدران، وهذه هي جريمته الكبرى في عيون من قرروا اغتياله. فقد فهموا أن لوحاته أشد خطورة من آلاف الخطب، لأنها تدخل إلى القلوب بغير استئذان، وتغرس شكوكًا لا تُمحى.
الاغتيال هنا لم يُنهِ الحكاية، وإنما أكملها. فالفنان الذي عاش حياته منحازًا للفقراء والمشردين، رحل بنفس الطريقة التي كان يتوقعها، ضحية لموقفه الثابت. هذا المصير جعله رمزًا مضاعفًا: رمزًا للفن المقاوم، ورمزًا للشهادة في سبيل الكلمة. صار جسده الغائب حاضرًا أكثر من أي وقت مضى، وصارت رسومه بعد موته أشبه بوصايا أخيرة للشعوب التي ما زالت تبحث عن خلاص.
إن موت ناجي العلي يؤكد أن الرصاص لا يستطيع أن يقتل فكرة، وأن الفنان الذي يختار الصدق يدرك مسبقًا أن دمه قد يصبح حبرًا أخيرًا يكتب به التاريخ. وهكذا، فإن الاغتيال لم ينجح في طمس صوته، وإنما رفعه إلى مقام الأسطورة، حيث يعيش في الذاكرة لا كرسام فقط، وإنما كضمير حي لا يُغتال.